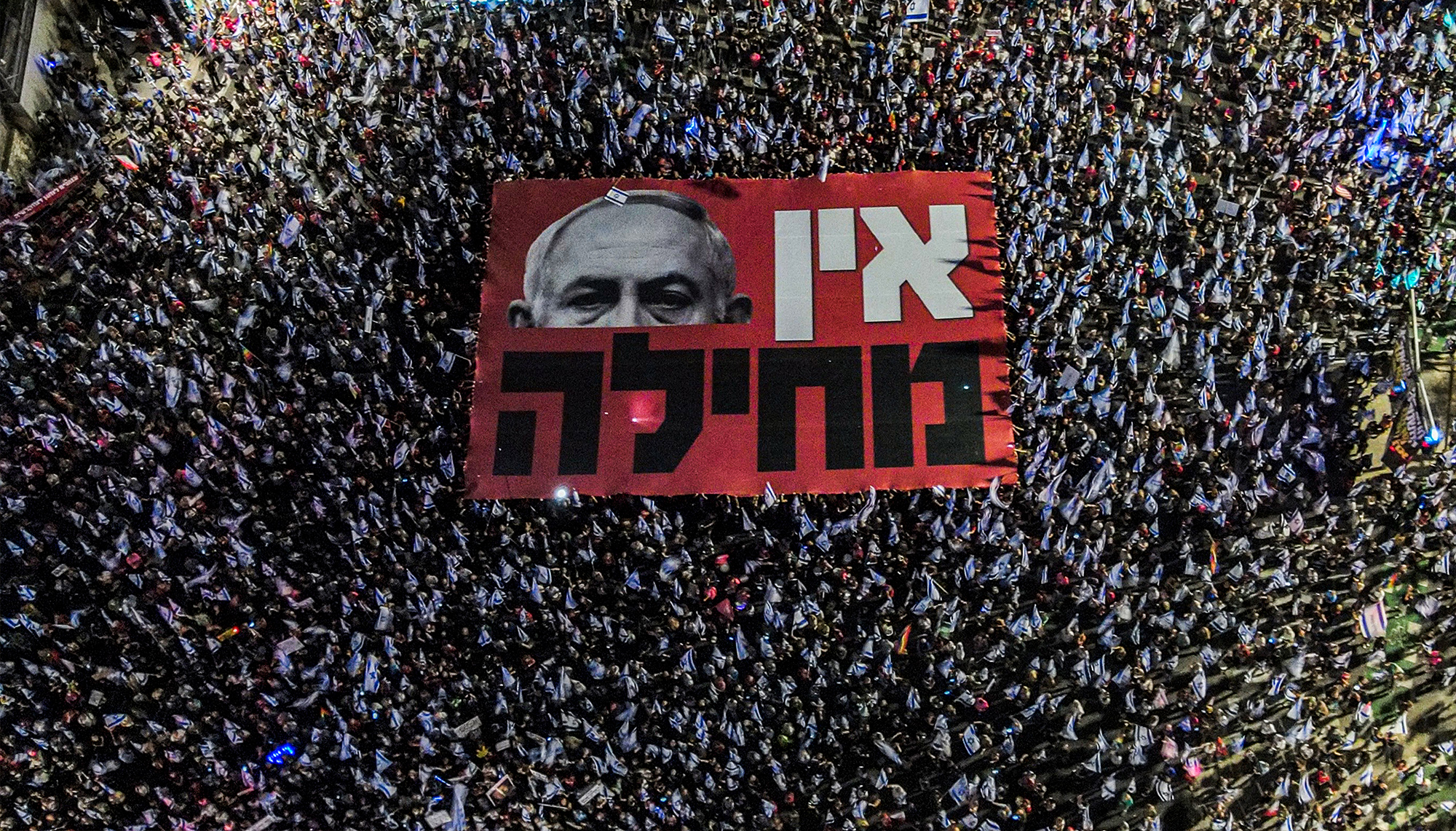بقلم هديل بدارنة*
(نشر هذا المقال في العدد الرابع والعشرين من مجلة جدل التي يصدرها مركز مدى الكرمل).
لم يكن سِجن الرجل الأبيض يومًا مجرّد جهاز رقابيٍّ ضبطيٍّ وضعه النظام ليعاقب مخالفي القانون، أو ليهذِّب مخرّبي المجتمع، فقد سبقت مؤسّسة السِّجن القوانين الجنائيّة الحديثة بما يقارب القرنين، وما كان الهدف من الأخيرة إلّا التمكين الإداريّ لمؤسّسات الحجز العقابيّة آنذاك وإضفاء الشرعيّة عليها. اتّخذت مؤسّسات الحجز أشكالًا متعدّدة عبْر التاريخ الأوروبي الحديث، تمظهرت في أقبية العبوديّة والعمل القسريّ في القرون الوسطى، وفي الاستعراضات العقابيّة الجماهيريّة وجُزُر العزل في المستعمرات الأوروبيّة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، حتّى هيئتها الحديثة التي تمأسست في القرن التاسع عشر.
تاريخيًّا، كان الأسْر حيّزًا لعزل «المجنون، المتمرّد، الأسود، الفقير، المثليّ/ة، المريض جنسيًّا، «العاهرات» وأطفالهنّ غير الشرعيّين إلخ»، وظلّ يعمل كأداة لإنتاج الجرائم والانحرافات، ومن خلاله جرى إخضاع الجسد المنحرِف لعمليّات «تأهيل» عقابيّة تحت آلة التعذيب في عزلة عن المجتمع، وفي منأًى تامّ عن الحيّز العامّ حتّى ينتقل هذا الجسد من الانحراف إلى صراط أكثر «استقامة» يليق بمجتمع «مستقيم» («Straight»).
وفي سياقنا المحلّيّ، لا يشكّل الأسْر السياسيّ الإسرائيليّ ذراعًا تنفيذيًّا للمعاقبة فحسب، بل هو انعكاس واضح لعلاقات القوى التي على تراكماتها الاقتصاديّة والجندريّة والعرْقيّة تعتاش كينونةُ المنظومة الإسرائيليّة كمنظومة رأسماليّة استعماريّة. فمنذ المعتقلات الأولى في العامين ١٩٤٨ و١٩٤٩ حتّى يومنا هذا، تسعى هذه المنظومة للتحكّم الديمغرافيّ، والرقابة الجماعيّة، والضبط الاقتصاديّ السياسيّ للسكّان الأصليّين الفلسطينيّين. وبحسب المعطيات، يقبع اليوم في السجون الإسرائيليّة ٥٨٠٠ أسيرٍ فلسطينيٍّ، من بينهم ٤١٤ معتقلًا إداريًّا، و٢٦ أسيرة، و١٨٢ طفلًا. هذه ليست أرقامًا مجرّدة منزوعة عن سياقها، وإنّما تتماشى أيديولوجيًّا مع التركيبة الديمغرافيّة في سائر سجون الأنظمة الاستعماريّة والرأسماليّة اليوم. على سبيل المثال، تشير الناشطة والكاتبة أنجيلا دافيس أنّ نسبة السكّان الأصليّين في أمريكا الشماليّة داخل السجون مقابل نسبتهم خارجه تصل حدّ الـ٤٠٪. أمّا إذا أخذنا أستراليا مثالًا آخر، فإنّنا نجد أنّ نسبة النساء الأبوريجنيليّات (من السكّان الأصليّين في أستراليا) تصل إلى ٣٠٪ من مجموع السجينات رغم أنّ نسبتهنّ الديمغرافيّة في المجتمع الأستراليّ لا تتجاوز 2٪.
تنعكس علاقات القوى المجنسنة في منظومة الأسْر الإسرائيليّ يوميًّا في السجون الإسرائيليّة، وذلك منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بمراحل التحقيق، وانتهاءً بالأسْر.
إضافة إلى آليّات الضبط والرقابة الاستعماريّة هذه، يعمل القانون والقضاء الإسرائيليّان جاهدَيْن على سلخ الفلسطينيّ/ة، ولا سيّما الأسير/ة السياسيّ/ة، عن «الشرعيّ» و«الأخلاقيّ»، وذلك من خلال ماكنة القَوْننة والقرارات الإداريّة التي بواسطتها أُطلِقت عليهنّ/م تسمية «الأسرى الأمنيّين» متوهّمًا أنّه بذلك يمكنه نزع الطابع «السياسيّ» أيضًا عن مسارهم النضاليّ، تمامًا كما في حال الأسرى الإيرلنديّين السياسيّين الذين وُصِموا بـ«الجنائيّين» في السجون البريطانيّة.
ومن هنا تحوّلت قوانين «مصلحة السجون» وقرارات المحكمة الإسرائيليّة، عسكريّة كانت أَم عليا، إلى أداة سياديّة تحيط بها هالة من العقلانيّة الإلهيّة، يروِّض بها المستعمِر بـ «موضوعيّة» ذاك المستعمَر المصاب بداء العاطفيّة المسعورة، تلك المتمثّلة بالنزعة البدائيّة العنفيّة والانحراف الهمجيّ نحو «الإجرام». وهكذا، عبر ماكنات القضاء الشرطويّ والبيروقراطيّ، يتجرّد المستعمِر من كلّ انتهاكاته الوحشيّة المعنِّفة ليتقمّص دور «الرجل العقلانيّ» كبنْية جندريّة جماعيّة ضابطًا بها المستعمَر، بدوره الجماعيّ «النسائيّ الهستيريّ» والمهدِّد للأمن والأمان.
في سعينا نحو تعرية آليّات القمع والإرهاب في منظومة السجن الإسرائيليّ، لا مفرّ من قراءة معمّقة تفكيكيّة لعلاقات القوّة بين الأسير والأسيرة من جهة، والسجّان والمحقِّق من جهة أخرى. سوف نتطرّق إلى جزء منها في هذا المقال، وسيجري من خلاله إلقاء الضوء على محرّكاتها الجندريّة والجنسيّة.
تنعكس علاقات القوى المجنسنة في منظومة الأسْر الإسرائيليّ يوميًّا بشتّى أبعادها في السجون والمعتقلات الإسرائيليّة، وذلك منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بمراحل التحقيق، وانتهاءً بالأسْر. بَيْدَ أنّها تبقى -غالبًا- على هامش النضال الفلسطينيّ في السجون، وكثيرًا ما يُنظر إليها كأنّها ظاهرة فرعيّة تندرج تحت «قضيّة الأسيرة الفلسطينيّة» أو «نضال المرأة»، وذلك بمعزل عن قراءة أوسع تدمج التحليل الجنسانيّ بالسياسيّ دون تجزئة للنضالات أو فرض هرميّة عليها.
لذا، تشكّل الكتابة، أو حتّى المواجهة الفكريّة، لتفكيك علاقات القوّة على وجهيها الاستعماريّ والجنسانيّ في منظومة الأسْر السياسيّ، تشكِّل تحدّيًا كبيرًا، ولا سيّما أمام حواجز الصمت والتعريفات المجمّدة لمفاهيم الشأن/الحيّز العامّ والشأن/الحيّز الخاصّ؛ إذ إنّه حتّى في العقليّة الفلسطينيّة المناهِضة للاستعمار والأسْر السياسيّ، تتحوّل غالبًا غرفة التحقيق في غضون لحظات من حيّز عامّ، حين نتحدّث عن آليّات التعذيب «السياسيّ»، إلى حيّز خاصّ إذا تحدّثنا عن آليّات التعذيب والعنف «الجنسيّ». وهذا بطبيعته يتبع الفصل الذكوريّ السائد بين «الجنسيّ» و«السياسيّ» والهوّة الوهميّة بينهما.
جنسنة الجسد السجين
إنّ سياسات الإرهاب والعنف الجنسيّ في المعتقلات والسجون الإسرائيليّة ما هي إلّا جزء لا يتجزّأ من النهج الإسرائيليّ الشموليّ، وخلالها تبرز صورة جليّة للذهنيّة والممارسة الاستعماريّة يجري وفقها توظيف الأدوار الجندريّة النمطيّة، والقوالب الاستشراقيّة الذكوريّة كفلسفة سلطويّة يتصرّف بحسبها الرجل الأبيض بزيّه كمحقِّق تارةً، وكسجّان تارة أخرى.
لا يَسْلم جسد الرجل الفلسطينيّ السجين من الجَنْسنة القمعيّة تحت وطأة الاستعمار، إلّا أنّ الأمر يغدو أكثر انتشارًا وحساسيّةً في حالة جسد المرأة الفلسطينيّة، حيث يجري استغلال مكوّناته الجنسيّة والجندريّة والسياسيّة لتنفيذ هذه الممارسات الذكوريّة كما سنوضّح لاحقًا. هذا لا يعني أنّ «المرأة» و«الجنسانية» كلمتان مترادفتان أو -كما تدّعي كاثرين مكينون- أنّ الجَنسانيّة للنسويّة هي كالعمل للماركسيّة؛ بل على العكس من ذلك تمامًا، تقع على كاهل النسويّة الكويريّة مسؤوليّة تناول الطبقة والعرْق والرجولة، في التنظير والممارسة، بالقدر نفسه الذي تتناول به الجنسانيّة، فلا يمكن لها في الواقع فصل هذا عن ذاك دون الوقوع في مطبّ ليبراليّ خطير.
خلال السنوات الأخيرة، وفي خضمّ إضراب الأسرى السياسيّين العامّ، طفت على السطح إفادات عديدة بلّغت فيها الأسيرات والأسرى عن آليّات العنف والتعذيب التي صمدوا في وجهها، دون حذف آليّات القمع الجنسيّ وأثرها الجسديّ والمعنويّ عليهنّ/م. وبذلك كُشِف جزئيًّا عمّا يحدث وراء قضبان الأسْر الإسرائيليّ عندما يتحوّل إلى «حيّز خاصّ» اصطلاحًا. وأكّدت عشرات الأسيرات السياسيّات الفلسطينيّات أنّ العنف الذي تمارسه سلطات الأسْر الإسرائيليّة يكون دائمًا مقرونًا بانتهاكات جنسيّة قاسية، وأنّ التفتيش المُعَرّي والتحرّش الجنسيّ اللفظيّ والجسديّ أثناء خروجهنّ إلى المحاكم، أو في الزيارات العائليّة، أصبح روتينًا مَقيتًا يَصْعب عليهنّ مواجهته في كلّ مرّة مَهما تَكرَّر. ومن الإفادات العديدة، تَبيَّن كذلك أنّه في أثناء التحقيق يقترب بعض المحقّقين منهنّ ويهدّدونهنّ بالاغتصاب كعقاب لصمودهنّ وعنادهنّ، أو ينزعون الحجاب عن رؤوسهنّ كوسيلة ضغط ومحاولة للإذلال وكآليّة للقمع الجنسيّ.
في إحدى الحالات، قال المحقّق للأسيرة، أثناء التحقيق بعد أن نزع الحجاب عن رأسها، إنّها «تثيره جنسيًّا هكذا… دون هذا الهراء الموضوع على رأسها»، مستغلًّا بذلك خلفيّةَ الأسيرةِ الدينيّةَ والمجتمعيّةَ المحافِظةَ وهندسَتَها الجندريّةَ كي يستمد استقواءً مضاعفًا، كرجل وكمستعمِر، بأسلوب استعلائيٍّ ذكوريٍّ، وكي يمارس وحشيته بقناع تقدّميٍّ علمانيّ. وفي جزء آخر من الشهادات، وبالإضافة إلى وابل من الألفاظ الجنسيّة المسيئة التي تنهال عليهن خلال الاعتقال، تكرّرت آليّة إرغامهنّ على تنفيذ وضعيّات لها إيحاءات جنسيّة من قِبل الجنود ابتغاءَ كسرهنّ معنويًّا.
هنا تجدر الإشارة أنّ موانع الإبلاغ والشكوى عن جملة الانتهاكات الجنسيّة التي تتعرّض لها الأسيرات والأسرى الفلسطينيّون في السجون الإسرائيليّة مضاعفة؛ فبالإضافة إلى الخوف من التنكيل الانتقاميّ وإعادة إحياء تجربة التعذيب، تصطدم الإفادات بجدار صمت اجتماعيّ ثقافيّ في ما يخص جَنسانيّة الجسد، ويزداد ذلك حسّاسيّةً في حال الأسيرة المرأة، إذ إنّه في حال تسريب هذه الشكاوى إلى الحيّز العامّ الفلسطينيّ يكون الثمن الاجتماعيّ والاقتصاديّ عليها باهظًا. من دلائل ذلك أنّه باتت التسمية المتداولة «تحقيق العار» تعود على التحقيق الذي يوظِّف فيه المحقِّق الإسرائيليّ آليّات تعذيب جنسيّة على جسد الأسيرة.
إنّ الفانتازيا الذكوريّة الاستشراقيّة كانت دائمًا مقرونة بجنسنة جسد المرأة كوسيلة لفرض الهيمنة البيضاء ثقافيًّا واقتصاديًّا.
أمّا المزاوجة بين العذاب أو التعذيب والجنس، وبين الألم والمتعة، فتَكون مرسَّخة ترسيخًا عميقًا في الذهنيّة الذكوريّة. ويتماشى هذا مع الاعتقاد الفرويديّ الذي بحسبه تتّصف المرأة بتعطّش كبير للألم والعذاب المتلاحمين باللذة والمتعة. يظهر هذا جليًّا في شهادة إحدى الأسيرات المحرَّرات التي روت عن تعرُّضها المؤلم لمحاولتَي اغتصاب حاملة معها آثاره النفسيّة والجسديّة حتّى اليوم. كانت لا تزال تذكره؛ «هو» (المحقِّق ليس أكثر من ضمير غائب في كلامها) يهدّدها لأنّها لم تُدْلِ بالاعترافات في التحقيق: «سأجعلك تتألمين من فرط المتعة، وعندها ستتكلّمين»… وقد أقرّت بشهادتها أنّ محاولات نسيان وجوه وأسنان وأظافر الضبّاط الذين تناوبوا على تعذيبها تبوء بالفشل مرّة بعد مرّة، وكأنّها أسيرة تجربة يستحيل فكّ قيودها رغم كونها اليوم «محرَّرة». في شهادة مروّعة كهذه، يتجسّد أمامنا جوهر «الأنوثة المازوشيّة»، أي إنّها -كمرأة وكفاعلة سياسيّة- لا تستشعر اللذّة، في نظر الجلّاد، إلّا إذا انقادت وخضعت له لتكون جسدًا سجينًا متصرِّفًا طوع أوامره السلطويّة.
إنّ الفانتازيا الذكوريّة الاستشراقيّة كانت دائمًا مقرونة، منذ أولى موجات الاستعمار، بجنسنة جسد المرأة وتغريضه (جعله غرضًا) كوسيلة لفرض الهيمنة البيضاء ثقافيًّا واقتصاديًّا. تبعًا لذلك، جرت معادلة أجساد نساء المستعمرات بالشهوانيّة الإيروسيّة المفرطة والتي تستوجب عنفًا جنسيًّا لنيل مآرب الهيمنة. لذا، ليس من المستغرب أن يصف الرحّالة الضائع كريستوفر كولومبوس بعقليّته الاستعماريّة عام ١٤٩٢ شكل الكون بالمستدير «أشْبه بنهد امرأة ممتلئ، يبحر به نحو قمّته».
من المهمّ الذكر أنّه إلى جانب آليّات التعذيب العنفيّة والظاهرة المذكورة أعلاه، تستتر أساليب تعذيب أقلّ فجاجةً، إلّا أنّها ليست أقلّ قسوةً، وهي ما يسمّى بـ«التعذيب الناعم». تتّسم هذه الآليّات بكونها هادئة صامتة ومتقنة بدقّة، يكون لها إيقاع ثابت وتأثير تراكميّ على أجساد ونفوس الأسيرات والأسرى. على سبيل المثال، ظروف الأسْر المتدنّية، في ما يخصّ المستوى الصحّيّ ونظافة الزنازين والأغطية والفرشات والتهوئة والإضاءة ودرجة الحرارة، كلّها تؤثّر على سلامة الأسيرات والأسرى النفسيّة، وفي أحيان كثيرة على صحّة أجسادهم/نّ المعرَّضة للأمراض والتلوُّثات.
الرجولة الذكريّة والرجولة الأنثويّة
تحيط بالرجولة في مجتمعنا هالةٌ من القداسة تنبثق عنها مكتسبات اجتماعيّة سياسيّة واقتصاديّة، لا يمكن إغفال ثقلها في المشروع القوميّ الفلسطينيّ ودَوْرها في تشكيل صورة المناضل المقاوم والأسير السياسيّ. إثر ذلك، ولكونها مفهومًا مضطهِدًا للرجل الفلسطينيّ أيضًا، تطمس الرجولة تَعَرُّض الأسير للاعتداءات الجنسيّة وتقمعه معتبرة إيّاه خضوعًا أو ضعفًا «أنثويًّا» يزجّ بالمعتدَى عليه في خانة اللارجولة.
لهذا ترتبط آليّات الإرهاب والعنف الجنسيّ، في حالة الأٍسير السياسيّ، بالمذلّة والهزيمة وأحيانًا حتّى بافتقاد العنصر «الرجوليّ القوميّ». إنّها هي نفسها الفلسفة الذكوريّة التي تفشل في اعتبار الصمود، بحدّ ذاته، قوّة أو حتّى باعتبار الانكسار صفة بشريّة، لا ضعفًا «أنثويًّا» شائنًا. نتيجة ذلك، قليلة هي الإفادات والكتابات التي تتطرّق إلى هذه الممارسات أو تقوم بنبشها.
كان الأمر مختلفًا تمامًا في حالة الأسير اللبنانيّ الشيخ مصطفى الديراني، المسؤول في عمليّة إخفاء «رون أراد»؛ ففي أعقاب تسريب أشرطة التحقيق وإقدام الديراني على التبليغ وتقديم الشكوى العلنيّة بعد التحقيق، انكشفت صور تعذيب مريعة تضمّنت الاغتصابَ وممارساتِ قمع وعنف جنسيّ مستمرّةً، وكانت جميعها بأوامر المحقّق «الكابتن جورج». حقّق الكابتن جورج مع الديراني شهرًا كاملًا وأرغمه على التعرّي طيلة الوقت، وكان يأمره بأن «يرفع تنّورته» للتعرّي الكامل، محاولًا بهذا أن يُسقط عليه دور الرجل «الأنثويّ»، مقابل رجولته الذكريّة السلطويّة -بوصفه هو محقِّقًا-، وأقسم إنّه سيشرف على اغتصابه الجماعيّ بواسطة عصًا إن لم يعترف. بتهديده الأخير، مارس المحقِّق السيطرة القضيبيّة القمعيّة -تلك النابعة من الهَوَس الذكوريّ بمركزيّة القضيب، وباعتباره مصدرًا مادّيًّا للامتيازات والقمعيّة الفحوليّة في الوقت ذاته.
الصمود حتى الحرّية
إنّ القوّة الكفاحيّة الكامنة في حالة الصمود المعنويّ في وجه التعذيب والتنكيل الإسرائيليّ أمرٌ يصعب على العقل استيعابه. فهذه العزيمة الهائلة بالتفوّق على المستعمِر في سجنه ومعتقلاته الغاشمة دونما «سلاح» سوى الذات المجرّدة، هذه العزيمة تتحدّى علاقات القوّة، وتُحيي الطابع الجماعيّ والسياسيّ بين الأسرى والأسيرات، وإنْ قبعوا في زنازين العزل الانفراديّ!
أمّا تغييبنا كمجتمع فلسطينيّ عن أساليب الاضطهاد الاستعماريّ الجنسيّ على أشكاله كافّة، أو حصره في خانة «المرأة» الأحاديّة الأبعاد ومن ثَمّ إهماله، دون خلق حيّز آمِن لطرحه ومناقشته ومجابهته، فيزيد الجلّادَ الإسرائيليّ قوّة ويفسح أمامه مسلكًا سلطويًّا ذكوريًّا خاليًا من العرقلات والمطبّات، كأنّنا جميعنا توقّفنا بصمت وخجل ما إن رأينا على مدخله إشارة «قف: تابو اجتماعيّ أمامك»، بدلًا من هدمه وتحطيمه.
إن مؤسّسة السجن الجاثمة على الأسرى السياسيّين كانت -ولا تزال- أحد أعمدة الكيان الصهيونيّ كمنظومة استعماريّة، وصمودُ الأسرى والأسيرات في وجهها ما هو إلّا درس في الروح النضاليّة والحياة، تعبّر عنه كلمات الأسير المحرَّر خضر عدنان: «وُلِدتُ حرًّا، ولن أذهب إلى السجن طواعيةً. احتجاز حرّيّتي واعتقالي هما اعتداء على هُويّتي وعلى وجودي».
*هديل بدارنة، ناشطة وباحثة حاصلة على شهادة الماجستير في القانون الدولي من جامعة جورجتاون (واشنطن).